عدالة الحاكم الإسلامي من وجهة نظر الإمام الخميني (ره)
بقلم: محمد باوي
ترجمة: وليد محسن
المقدمة:
من أهم الأسئلة التي تطرح في الفكر السياسي هو أنه كيف يمكن الحيلولة من حدوث الاستغلال في السلطة دون الإخلال في قدرتها على أداء واجباتها الأساسية؟ بشكل عام، يمكن السيطرة على القدرة السياسية بطريقين: داخلي وخارجي. أما الطريق الداخلي فيعني وجود صفات خاصة في شخصية الحاكم تمنعه من استغلال السلطة. وأما الطريق الخارجي فيعني إيجاد أساليب ناجحة للإشراف على السلطة السياسية ومراقبتها والسيطرة عليها بواسطة المؤسسات البشرية. ويمكن الجمع بين هذين الأسلوبين في السيطرة على استغلال السلطة، لكن شيوعهما في الفكر السياسي قد دفعنا لمناقشة وتصنيف الآراء السياسية التي تبين كيفية السيطرة على استغلال السلطة. وتتفاوت إجابة المفكرين السياسيين حول كيفية السيطرة على السلطة حسب فهم وإدراك كلّ واحد منهم للسلطة ولقيمتها الأخلاقية. فالرؤية التي تعتبر السلطة خيراً بالذات، تعتقد بالأسلوب الداخلي في السيطرة عليها، وفي المقابل الرؤية التي تعتبر السلطة مصدراً للشر والفساد، تؤمن بالاستفادة من الأسلوب الخارجي للسيطرة على السلطة. والسؤال الأصلي لهذه المقالة هو: ما هو الأسلوب الأساسي للحيلولة دون استغلال السلطة في الفكر السياسي للإمام الخميني (ره)؟
وقد ذكرنا في موضع آخر بالتفصيل أن السلطة من وجهة نظر الإمام الخميني (ره) هي خير بالذات[1] وقد وهب الله تعالى حق تطبيقها في الوهلة الأولى إلى الأنبياء والأئمة المعصومين (عليهم السّلام). فهم يمثلون المصاديق التامة للإنسان الكامل وقد حصلوا عليها في سفرهم المعنوي للحق تعالى، لكنهم لم يختاروا العزلة والانزواء عن الخلق، وقد أمرهم الله بتوضيح الطريق وهداية المذنبين والمنحرفين. وقد وصلوا إلى هذه المرحلة من الكمال في ذلك السفر المعنوي[2].
إن العصمة هي الصفة التي كانت تمنع الأنبياء )عليهم السلام( من الوقوع في الاشتباه وارتكاب الذنب، ويعرف الإمام العصمة قائلاً:
«إنها حالة نفسانية ونور باطني يحصل من النور الكامل لليقين والاطمئنان»[3].
وثمرة هذه المشاهدة الحضورية هي اليقين الذي يتمثل في أسمى صوره في الإمام علي (ع) عندما يقول: «لَوْ أُعْطِيتُ الْأَقَالِيمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاكِهَا عَلَى أَنْ أَعْصِيَ اللَّهَ فِي نَمْلَةٍ أَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِيرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ»[4].
وبناءً على ذلك، في ظل حكومة الإمام المعصوم (ع) لا فقط أنه لا يشعر أحد بأي قلق إزاء استغلال السلطة فحسب؛ بل إن تصدي الإمام المعصوم للحكومة سيمنع المسئولين الآخرين في الحكومة من استغلال السلطة ويمنع تجاوز المواطنين على بعضهم البعض، مما يساعد على قيام المجتمع الإسلامي المثالي والمدينة الفاضلة. لكن للأسف، كان عمر مثل هذه الحكومة قصيراً جداً على مرّ التاريخ، وكان نموذجها الأخير في حكومة الإمام علي (ع)، وكانت مصيبة سلب الحكومة منه هي المصيبة العظمى التي حلت بالإسلام[5].
وفي عصر غيبة الإمام المعصوم (عليه السّلام)، يتولى الفقهاء الجامعون للشرائط أمر الحكومة في المجتمع الإسلامي، ويحل فيهم شرط العدالة بدلاً عن شرط العصمة في الإمام المعصوم.
تعريف العدالة:
يمكن بحث موضوع العدالة في ثلاثة اتجاهات مختلفة: الأخلاقي والعرفاني والفقهي. وفي مؤلفات الإمام الخميني (قدّس سرّه) يمكن أن نجد أشارة إجمالية إلى هذه الاتجاهات الثلاثة أو توضيحات مفصلة عنها:
1ـ التعريف الأخلاقي:
في كتاب (الأربعون حديثاً) أشار الإمام إلى نظرية علماء الأخلاق حول العدالة، التي تقسم قوى النفس الإنسانية إلى: قوة النفس الناطقة، والقوة الغضبية والقوة الشهوية، كما تتلخص مجموعة الفضائل بأربعة فضائل، هي: الحكمة، والعفة، والشجاعة، والعدالة، حيث اعتبرت الحكمة فضيلة النفس الناطقة المميزة، والشجاعة فضيلة النفس الغضبية، والعفة فضيلة النفس الشهوية، والعدالة تعديل للفضائل الثلاث[6]. وفي موضع آخر اعتبر العدالة بمعنى الحد الوسط، أي الخروج من حد الإفراط والتفريط وأنها تمثل ملاك الفضيلة أو الخلق الحسن. فمثلاً الشجاعة تمثل الحد الوسط بين الإفراط في التهور والتفريط في الجبن في القوة الغضبية؛ وعلى هذا الأساس عند وجود الشجاعة يمكن القول بعدالة القوة الغضبية[7]. ولبيان هذا المقصود من العدالة، غالباً ما استعمل علماء الأخلاق كلمة الاعتدال للتعبير عن العدالة بمعناها الأول؛ وكان الإمام الخميني (قدّس سرّه) أيضاً غالباً ما يستعمل العدالة في معناها الأول.
والإنسان عندما يحرم من الاستفادة من نعمتي العقل والشرع، يفقد عادة زمام اختياره ويسقط بيد قوى الغضب والشهوة ويتجه نحو صفة الحيوانية، أما إذا وقعت ملكة إنسانية هذا الإنسان تحت تأثير تعليم الأنبياء وتربية العلماء والمربين، ويسلم نفسه تدريجياً إلى القوة المربية عند الأنبياء والأولياء (عليهم السّلام)، فمن الممكن أن لا يمضي وقت طويل حتى يجد قوته الإنسانية الكاملة قد انتقلت من حالة الاستعداد والقابلية التي أودعها الله فيه إلى حالة الفعلية، وتعود جميع شؤون وقوى مملكته إلى شأن إنسانية الشيطان الذي آمن على يده؛ كما حدث مع الرسول الأكرم (ص) عندما قال: إن شيطاني آمن بيدي[8]. ويخضع مقام حيوانيته إلى سيطرة مقام إنسانيته، بحيث ينتقل هذا المركب المرتاض نحو عالم الكمال ويرتقي في السماء ليطوي طريق الآخرة ويبتعد تماماً عن المعصية والهيجان، وبعد تسليم قوة الشهوة والغضب إلى مقام العدالة والشرع، تسود العدالة في مملكته وتقام فيها الحكومة العادلة الحقة التي يكون العمل والحكم فيها هو الحق وقوانين الحق، ولا يرتكب فيها ما يخالف الحق وتبتعد تماماً عن الباطل والجور[9].
إنّ السير الذي يوصل الإنسان إلى إتباع العقل والشرع ويوقفه إلى تحقيق ملكة العدالة، يطلق عليه اصطلاح تهذيب النفس وهو يمثل الغاية النهائية لعلم الأخلاق. ويعرّف الإمام (قدّس سرّه) تهذيب النفس:
«هو غلبة الإنسان على قواه الظاهرة وجعلها تحت أمر الخالق وتطهير مملكته من تلوث قوى الشيطان وجنوده»[10].
2ـ التعريف العرفاني:
للوقوف على التصور العرفاني للإمام (قدّس سرّه) عن مفهوم العدالة، وعلى الرغم من عدم وجود عبارات صريحة في كلامه عن هذا الموضوع؛ لكن يمكن الاستناد إلى رسالته العرفانية التي كتبها إلى ولده والتي تضمنت تفسيراً للآية الثامنة عشر من سورة الحشر:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾.
للإيمان مراتب متعددة آخرها مرتبة العصمة التي تظهر عند الإنسان الكامل. أما قبل هذه المرتبة توجد مراتب أخرى يكون للتقوى في كلّ واحدة منها معنى يختلف عن الأخرى، وبالنتيجة يتغير مفهوم العدالة أيضاً من مرتبة إلى مرتبة أخرى، ويتغير من مرحلة إلى مرحلة أعلى.
المرتبة الأولى من مراتب الإيمان هي مرتبة الإيمان العامة التي تمثل الابتعاد عن مخالفة أحكام الله، وترتبط بأعمال القلب[11].
المرتبة الثانية: هي الإيمان الذي يصل القلب ويبعد الإنسان عن المعصية[12]. والتقوى في هذه الصورة هي التقوىعن التوجه إلى الغير، والتقوى عن طلب العون والعبودية لغير الحق، والتقوى عن السماح بدخول غير الحق جل وعلا للقلب، والتقوى عن الاتكال والاعتماد على غير الله[13].
المرتبة الثالثة من الإيمان، هي إيمان الخواص من أهل المعرفة الذين يرون بعين القلب والمعرفة الباطنية جميع الموجودات كمظهر للحق تعالى، ويشاهدون نور الله في كلّ ما هو مرئي[14].
والتقوى في هذه الصورة هي التقوى عن رؤية الكثرة، رغم أنها تظهر بصورة التوجه إلى الحق من الخلق.
أما المرتبة الأخرى للإيمان فهي إيمان الأولياء الخلص، الذين انتقلوا من مرحلة رؤية الحق في الخلق وجماله تعالى إلى مرحلة الحجة الفعلية... وفي هذا الاحتمال يكون الأمر بالتقوى الاجتناب عن رؤية الكثرة الأسمائية والتجليات الرحمانية والرحيمية وغيرها من أسماء الله[15]. والاحتمال الأكثر جامعية هو حمل الإيمان والتقوى في الآية على معناهما المطلق واعتبار جميع مراتبها حقائق وضعت ألفاظها وعناوينها للتعبير عن المعنى المطلق غير المقيد بأي حد[16].
ويوجد في كلّ مرتبة من مراتب الإيمان مفهوماً جديداً للمعصية؛ ولهذا يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربين. على هذا الأساس، يكون لمفهوم العدالة أيضاً مراتب متعددة تنطبق كل واحدة منها على مرتبة من مراتب الإيمان. وبالطبع لم يشر الإمام (قدّس سرّه) في هذه الرسالة إلى مفهوم العدالة؛ لكنه صرح فيها بعدم استصغار أي ذنب على قول «أنظر إلى من عصيت» فتصبح جميع الذنوب من الكبائر[17]، وكل منها يخالف العدالة بمفهومها العرفاني.
3ـ التعريف الفقهي:
الإمام الخميني (قدّس سرّه) في كتاب تحرير الوسيلة يعرّف العدالة على النحو التالي:
«العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرمات وفعل الواجبات»[18].
وفي مبحث شرائط إمام الجماعة ذكر الإمام (قدّس سرّه) تعريفاً آخر للعدالة أوضح من التعريف السابق:
«العدالة عبارة عن حالة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى عن ارتكاب الكبائر والصغائر على الأقوى، فضلاً عن الإصرار عليها الذي عدّ من الكبائر، وعن ارتكاب أعمال دالة عرفاً على عدم مبالاة فاعلها بالدين، والأحوط أن اجتناب ما ينافي المروءة معتبر في العدالة أيضاً، وإن كان الأقوى عدم اعتباره»[19].
ويمكن معرفة الكبائر من عدة طرق:
1ـ كلّ معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو بالعقاب أو شدد عليها تشديداً عظيماً.
2ـ ما دل دليل على كونها أكبر من بعض الكبائر أو مثلها.
3ـ ما حكم العقل على أنها كبيرة.
4ـ ما كان في ارتكاز المتشرعة كذلك.
5ـ ما ورد نصٌ على كونها كبيرة[20].
والكبائر كثيرة، منها:
اليأس من روح الله، والأمن من مكره، والكذب عليه، وعلى رسوله وأوصيائه (ع)، وقتل النفس التي حرمها الله إلاّ بالحق، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلماً، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وقطيعة الرحم، والسحر، والزنا، واللواط، والسرقة، واليمين الغموس، والحيف في الوصية، وشرب الخمر، وأكل الربا، وأكل السحت، والقمار، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله من غير ضرورة، والبخس في المكيال والميزان، والتعرب بعد الهجرة، ومعونة الظالمين، والركون إليهم، وحبس الحقوق من غير عذر، والكذب، والكبر، والإسراف، والتبذير، والخيانة، والغيبة، والنميمة، والاشتغال بالملاهي، والاستخفاف بالحج، وترك الصلاة، ومنع الزكاة، والإصرار على الصغائر من الذنوب[21].
إن الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر هو المداومة والملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة، ولا يبعد أن يكون الإصدار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها وإن لم يعد إليها خصوصاً إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الأولى. نعم الظاهر عدم تحققه بمجرد عدم التوبة بعد المعصية من دون العزم على العود إليها[22].
ويعتبر شرط تحقق العدالة الفقهية في ستة أشخاص. مرجع التقليد، القاضي، إمام الجماعة، الشاهد، والحاكم الإسلامي.
العدالة شرط ضروري في الحاكم الإسلامي:
في عصر الغيبة وحيث لا يمكن الوصول إلى الإمام المعصوم، واستناداً إلى العديد من الآيات والروايات، ينتقل حق تطبيق الحكومة إلى الفقيه الجامع للشرائط. وقبل أن يثبت الإمام ولاية الفقيه في حكومة المجتمع الإسلامي في مباحث خارج الفقه أثناء إقامته في النجف الأشرف، كان قد أشار في بعض مؤلفاته الأخرى إلى ضرورة حكومة الفقيه الجامع للشرائط[23]. والموضع الوحيد الذي يظن فيه أن الإمام كان له رأي آخر في هذا الموضوع، هو ما ذكره في كتاب كشف الأسرار الذي ألفه في سنة 1323ﻫ.ش.
فبعد أن عمد الإمام (قدّس سرّه) في هذا الكتاب إلى إثبات الضرورة العقلية والشرعية لوجود الحكومة، صرّح:
«إننا لا نقول بوجوب أن يتولى الفقيه الحكومة بل نقول بوجوب إدارة الحكومة على أساس القانون الإلهي وما فيه صلاح البلد والشعب وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق بدون إشراف رجل الدين»[24].
وبهذا الغرض، ينبغي تشكيل مجلس يضم عدداً من المجتهدين المتدينين العارفين بأحكام الله العادلين البعيدين عن الأهواء النفسية غير الملوثين بشهوات الدنيا وحب الرئاسة الذين لا يهتمون إلاّ بمصلحة الناس وتطبيق أحكام الله، فينتخبون سلطاناً عادلاً لا يتخلف عن تطبيق قوانين الله ويتجنب الظلم والجور ولا يتعدى على مال الناس وأرواحهم وأعراضهم[25]. وإذا لم يمكن تشكيل مثل هذا المجلس، فعلى الأقل يتم العمل بالدستور ويتم تشكيل مجلس الشورى تحت إشراف المجتهدين[26].
الظاهر أن نظرية الإمام (قدّس سرّه) في كتاب كشف الأسرار يطلق عليها إشراف الفقيه بدلاً من ولاية الفقيه[27]. أو يمكن أن نعتبرها صورة أخرى عن ولاية الفقيه، وكيفما كان فإن المهم عندنا أن الإمام الخميني (قدّس سرّه) حتى عندما يمنح القدرة للسلطان ويجعل المجتهدين في مقام انتخاب السلطان والإشراف على عمله، يعتبر العدالة شرطاً في الحاكم والسلطان العادل المنتخب من قبل المجتهدين إذا لم يكن عارفاً بقانون الإسلام، فيجب عليه في هذا المورد الرجوع إلى المجتهدين، لكن على كلّ حال يشترط فيه أن يكون عادلاً.
الإمام الخميني (قدّس سرّه) يعتبر العدالة شرطاً ضرورياً في ولاية الفقيه أيضاً؛ لأن الشخص الذي يريد تطبيق الحدود؛ أي الذي يطبق القانون الجزائي في الإسلام ويتصدى لإدارة بيت المال وتنظيم مصاريف الدولة، ويمنحه الله اختيار تنظيم أمور عباده، يشترط فيه أن يكون بعيداً عن المعصية: ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ إنما هي في حالة تحقق العدالة الحقيقية في المجتمع عن طريق العمل بقوانين الإسلام[28].
أما إذا كان الحاكم الإسلامي فقيهاً، لكنه لم يكن عادلاً، فإنه لن يتصرف بعدالة في إعطاء حقوق المسلمين. وأخذ الضرائب وصرفها بشكل صحيح وتطبيق قانون العقوبات، ومن الممكن أن يفرض على المجتمع القبول بأعوانه وأنصاره والمقربين منه، ويتصرف ببيت مال المسلمين لتحقيق مآربه وأغراضه الشخصية[29].
فالفقيه الذي يسقط في مستنقع حب الدنيا لا يمكن أن يكون أميناً للرسول الأكرم ومنفذاً لأحكامه[30].
وفي سبيل تحقيق أهوائه ورغباته الدنيوية قد يلجأ إلى خيانة الدين وتصبح حاله كحال الرواة الذين يجعلون الرواية ضد الإسلام[31].
إذن، النتيجة هي أن العدالة في عصر الغيبة- حيث لا يمكن الوصول إلى الإمام المعصوم - تعتبر شرطاً ضرورياً في الحاكم الإسلامي، حتى لا يستغل سلطته؛ سواء كان هذا الحاكم سلطاناً عادلاً أو فقيهاً عادلاً.
4ـ العدالة والغاية الحقيقية للسلطة السياسية:
إن هداية الناس وتهذيب نفوسهم تعتبر الغاية الحقيقية والنهائية للسلطة السياسية. وكما أن فساد الحكومة يؤدي إلى فساد المجتمع، فإن صلاح الحكومة يؤدي إلى صلاح المجتمع، وهذا الأمر يرتبط بتولي فرد صالح لمنصب الحكومة:
«إن الإنسان أو الملك أو الرئيس إذا ما كان مهذباً وصالحاً، فإنه سيؤثر على جميع من حوله ويجعلهم صالحين، وهم أيضاً تسري صحة عملهم إلى من هم أدنى مرتبة منهم، لعلكم قد ترون أن حاكماً عادلاً لو حكم بين الناس عشرين عاماً، لأوجد بلداً عادلاً، ولو ظهرت حكومة صالحة في منطقة ما، فإن الناس في تلك المنطقة سيصبحوا صلحاء أيضاً؛ لأنهم يتبعون ما تقوم به تلك الحكومة»[32].
ورغم أن العدالة من الناحية الفقهية تذكر شرطاً في موارد محددة، لكن الولي الفقيه على رأس الحكومة الإسلامية يسعى لنشر مكارم الأخلاق في كلّ مجتمع استمراراً لرسالة الأنبياء؛ وبعبارة أوضح، الولي الفقيه حسب رأي الإمام (قدّس سرّه) هو معلم أخلاق يجلس على كرسي الحكم. وينتج عن حكومة الفقيه العادل زيادة عدد الأفراد العادلين، مما يؤدي إلى حركة المجتمع نحو الصلاح والسداد. فالمجتمع المتكون من أناس عادلين هو مجتمع عادل. وعلى هذا الأساس يعتقد الإمام (قدّس سرّه) أن المجتمع الذي تقوده حكومة عادلة ينبغي أن يكون الجميع فيه عدولاً، وعلى كلّ فرد في أي مقام كان أن يعمل تدريجياً على تزكية نفسه ليكون فرداً عادلاً[33].
إن هذا الأمر يتطلب من الحكام والمربين في المجتمع تهذيب أنفسهم، وهذا العمل يعد من ثمار الأخلاق وليس الفقه؛ لهذا كان الإمام (قدّس سرّه) يؤكد دائماً في خطاباته خاصة مع فضلاء الحوزات العلمية على ضرورة تهذيب النفس؛ ويمكن ملاحظة شدة هذه الدعوة في كتابه الجهاد الأكبر.
فالإمام في هذا الكتاب، يحذر الحوزات العلمية من الأخطار والمسؤوليات التي تواجه رجال الدين، ويقول:
«إن أيادي الاستعمار تريد القضاء على جميع حيثيات الإسلام؛ لذا يجب عليكم التصدي لهم؛ لكن لا يمكن مقاومتهم بحب النفس وحب الجاه والكبر والغرور، فعالم السوء وهو العالم الذي يلهث وراء الدنيا، ولا يفكر سوى بالحفاظ على كرسي الرئاسة، لا يمكنه مواجهة أعداء الإسلام ويكون ضرره أكثر من الآخرين»[34].
ويوصي الإمام (قدّس سرّه) رجال الدين بتهذيب النفس، فيقول:
«إنكم تسعون إلى تهذيب المجتمع وإرشاده؛ لكن من يعجز عن إصلاح نفسه وإدارتها كيف يمكنه إرشاد الآخرين وإدارتهم؟»[35].
ويشير الإمام (قدّس سرّه) إلى آفات عدم تهذيب النفس عند رجال الدين، فيقول:
«ما لم تصبحوا محل اهتمام الناس، عليكم أن تفكروا بحالكم. فلا سمح الله لو أن شخصاً أصبح مورد اهتمام الناس قبل أن يتمكن من تهذيب نفسه، ويحظى بينهم بمكانة ومنزلة رفيعة، فإنه سيخسر نفسه ويضل الطريق؛ لذا يجب عليكم السعي لتهذيب أنفسكم وإصلاحها قبل أن تفقدوا زمام اختيارها»[36].
طرق تشخيص العدالة:
1ـ المرجع وإمام الجماعة:
تذكر الكتب الفقيهة عدة طرق لإثبات عدالة الشخص؛ فمثلاً تثبت العدالة في مرجع التقليد والقاضي، بشهادة عدلين وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان، وبالشياع المفيد للعلم؛ بل تعرف بحسن الظاهر ومواظبته على الشرعيات والطاعات والحضور في صلاة الجماعة ونحوها[37]. وتثبت في إمام الجماعة أيضاً بالبينة والشياع الموجب للاطمئنان[38].
كما أنه يكفي حسن الظاهر الكاشف ظناً عن العدالة بل الأقوى كفاية حسن الظاهر ولو لم يحصل من الظن وإن كان الأحوط اعتباره[39].
كذلك: الأقوى جواز تصدي الإمامة لمن يعرف من نفسه عدم العدالة مع اعتقاد المأمومين بعدالته، وإن كان الأحوط الترك، وهي جماعة صحيحة يترتب عليها أحكامها[40]. ولو تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو محدثاً صح ما صلى معه جماعة ويغتفر فيه ما يغتفر في الجماعة[41].
ومن الضروري هنا أن نبين أن العدالة الفقهية تتطابق من جهة مع تعريف العدالة الأخلاقية. فعدالة النفس التي تتحقق عن طريق مجاهدة النفس وتهذيبها، تمنع من ارتكاب الذنب، وكلما كانت مرتبة الإيمان أعلى كانت شدة الامتناع عن ارتكاب الذنب أكبر.
وعلى هذا الأساس، تتحقق العدالة الفقهية نتيجة لمجاهدة النفس وتحقق العدالة الأخلاقية في نفس الإنسان؛ لكن عندما يجري الحديث عن طرق إثبات العدالة يتم الفصل بين العدالة الفقهية والأخرى.
فالأخلاق تسعى لتحقيق عدالة النفس عن طريق العمل بالأحكام والوصايا الأخلاقية؛ لذا يمكن القول أن العدالة في الأخلاق هي عدالة حقيقية؛ أما العدالة الفقهية فيتم إثباتها بحسن الظاهر أو الشهادة أو بالطرق التي تم ذكرها سابقاً؛ وبالطبع إثبات العدالة من الناحية الفقهية، لا يعني بالضرورة تحقق العدالة بشكل حقيقي وكما تهدف إليه الأخلاق.
2ـ الولي الفقيه
هل أن طرق إثبات العدالة في الولي الفقيه هي نفس الطرق التي ذكرناها في إثباتها في المرجع وإمام الجماعة؟ وبشكل عام ما هو رأي الإمام في القائد العادل، وكيف يتم تعيينه لتولي السلطة والحكومة؟
يعتبر الإمام (قدّس سرّه) سعي الفقيه الجامع للشرائط الوصول إلى السلطة السياسية واجباً عينياً؛ لكنه في الوقت ذاته يؤكد على ضرورة أن يخلو هذا السعي من كلّ آفات حب السلطة المنافية للعدالة. وضمن بيانه لمسائل صلاة الجماعة، يقول (قدّس سرّه):
«لو تشاح الأئمة فالأحوط الأولى ترك الاقتداء بهم جميعاً»[42].
وفي مجال المرجعية وقيادة المجتمع، فما دام يوجد من به الكفاية لهذا المقام، ينبغي اجتناب التظاهر وحب الشهرة وحب السلطة. ويعد سلوك الإمام في قبال مسألة المرجعية نموذجاً بارزاً لاعتقاده بهذا الأصل؛ حيث يذكر الكثير من تلامذته أن الإمام (قدّس سرّه) شخصاً لم يسع أبداً لكسب مقام المرجعية، وكان منذ البداية يتجنب كلّ عمل تشوبه آفة حب الشهرة والمقام[43]. أما في السياسة، فلا تجد أحداً بين الفقهاء والمراجع آنذاك يحمل بقدر ما كان يحمله من دوافع وأفكار سياسية؛ لهذا رأى أن من الواجب عليه التصدي لهذا الأمر[44].
إن من الصعب التوصل إلى رؤية نظرية محدودة للإجابة عن السؤال حول كيفية معرفة الفقيه العادل، من خلال تحليلنا للعملية المعقدة التي انتهت بتولي الإمام (قدّس سرّه) لمقام قيادة الثورة الإسلامية بلا منازع. كما لا يمكن الحصول من تحليل فكر الإمام (قدّس سرّه) على تفسير لهذه العملية حتى يمكن طرحه كجزء من فكره السياسي. وهذا التعقيد في مسألة تولي الإمام لمقام القيادة قد جعل من شورى مراجعة الدستور (1368هـ.ش) إلى اعتبار مسألة وصول الإمام إلى مقام قيادة المجتمع مسألة فريدة من نوعها، وحددوا في الدستور طريقة انتخاب القائد بانتخابه في مجلس الخبراء في مرحلتين.
3ـ الرأي الحر للشعب:
قبل انتصار الثورة الإسلامية وتأييد الدستور الذي تضمن تحديد طريقة انتخاب القائد في مرحلتين، كان الإمام (قدّس سرّه) يرى أن تعيين الحاكم الصالح[45] يتم بالرجوع إلى الرأي الحر للشعب وكان الإمام يعتبر الحرية أول حق بشري اعترف به جميع العالم[46]. كما أن الحرية تعتبر أحد الأصول الثلاثة في شعار الجمهورية الإسلامية؛ وعلى هذا الأساس، تعتبر الحرية في انتخاب الحاكم ـ باعتباره يرتبط بأمور البلاد ـ حقاً أولياً للأفراد[47].
وقد وجه الإمام (قدّس سرّه) أهم انتقاداته لحكومة الشاه في هذا الجانب، وبشكل عام كان النظام الملكي نظاماً متخلفاً ورجعياً وعديم الفائدة؛ لأنه لم يمنح الشعب أبداً حق تعيين السلطان[48]. كما أن محمد رضا بهلوي لم يكن منتخباً من قبل الشعب؛ لذا فإنه فاقد للشرعية حتى على أساس دستور الحركة الدستورية (المشروطة)[49].
وإضافة لكون الشاه لم يكن منتخباً من قبل الشعب، كان قد سلب الحرية من الناس؛ ومن يسلب الناس حريتهم لا يصلح لتولي أمور السلطنة، وحتى لو كانت سلطنته قانونية، فهو الآن لم يعد سلطاناً[50]. وفي حديثه مع المراسلين الأجانب، أكد الإمام (قدّس سرّه) أيضاً، إنني أعارض أصل السلطنة والنظام الملكي في إيران؛ لأن السلطنة في الأساس هي حكومة لا تستند على آراء الشعب[51].
4ـ الفقيه العادل وانتخاب الشعب:
إن الإمام الخميني (قدّس سرّه) لا يؤكد على حرية الشعب في انتخاب الحاكم لمجرد كونه حقاً لهم؛ بل لأنه كان يعتقد أن مسألة انتخاب الحاكم لو تركت للشعب لانتخبوا حتماً حاكماً صالحاً:
«لو ترك للشعب حرية الانتخاب لانتخبوا حتماً فرداً صالحاً فلا يمكن للرأي العام أن يخطئ (...) إذ أن كلّ شعب عندما يريد تعيين شخص مسؤول على مصير بلدهم؛ فإنهم سيختارون حتماً شخصاً صالحاً لا فاسداً؛ وحتماً لا يحصل الاشتباه عند ثلاثين مليون نسمة»[52].
وهذا يطرح السؤال التالي: ما هو الأساس الذي يستند إليه الإمام في اعتقاده بصحة رأي الشعب؟
أن الإمام (قدّس سرّه) يحمل رؤية سلبية حول النوع الإنساني ويعتبره في بادئ الأمر حيواناً بالفعل، ما لم تتم هدايته بواسطة قوة العقل والشرع. والغاية الحقيقية للسلطة السياسية هي تهذيب الأخلاق، ومنشأ إصلاح المجتمع هو الحكومة الصالحة، ومنشأ فساده الحكومة الفاسدة. ونظراً لهذه الفرضيات واعتقاد الإمام بفساد حكومة الشاه وإفسادها للمجتمع، كيف يمكن الاطمئنان بقدرة الشعب على انتخاب الفرد الصالح حتماً وبعدم خطأ الرأي العام؟
للإجابة على هذا السؤال، ينبغي التأمل مرة أخرى بهذا الكلام، إذ ليس من الواضح تماماً أن الفرد الصالح في هذا الكلام، هل يشمل الفقيه الجامع للشرائط الذي يتولى قيادة المجتمع أو لاً؟
وفي إشارته لنظرية أفلاطون حول ضرورة حكومة الفلاسفة، يقول الإمام:
«الفلاسفة أيضاً حتما من الصالحين، فنحن نقول أن الشخص الذي يريد إدارة البلاد، الذي نريد تسليمه مهمة إدارة أمورنا، يجب أن ينتخبه الشعب، ويتصدى للمسؤولية بانتخاب الشعب»[53].
من هذه العبارة والمقارنة بين الفيلسوف أفلاطون والشخص الصالح عند الإمام، ربما يبدو منها أن الفقيه الجامع للشرائط يتم تعيينه بنفس هذا الأسلوب وحسب هذه القاعدة؛ لكن عند ملاحظة قسم آخر من هذا الكلام، يتضح أن الإمام كان يرى أن تهيئة الظروف المناسبة التي تمكن الشعب من إبداء رأيه بحرية إنما يتحقق في ظل إقامة حكومة صالحة؛ لأن الشعب لا يمكنه إبداء رأيه بحرية في ظل حكومة فاسدة تسلب منه حرياته[54].
وعلى هذا الأساس، كلما يتم استبدال الحاكم الفاسد بحاكم صالح، كلما تمكن الشعب من المشاركة في انتخابات حرة، وإبداء رأيه حول نوع النظام السياسي والأشخاص الذين يتولون مهمة التصدي لإدارة أموره (كما حصل في تجربة السنة الأولى للثورة). وفي هذا الكلام اعتبر الإمام (قدّس سرّه) أن المنتخبين من قبل الشعب هم رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس[55]، ولم نجد فيه ما يدل على اعتقاده بإعطاء حق انتخاب الفقيه العادل للشعب.
إن الإمام في كلامه هذا اعتبر عمله مستنداً إلى رأي الشعب وتأييدهم العام له، لكنه لم يعتبر نفسه أبداً منتخباً من قبل الشعب. إن التأييد العام للشعب يوجب بسط يد الفقيه العادل ويجعله قادراً على القيام بتكليفه الإلهي على أكمل وجه؛ لأن تأييد الشعب وقبولهم يعتبر شرطاً أساسياً وضرورياً لنجاح الفقيه العادل في أداء وظائفه. وعلى ضوء ما تقدم، وبالنظر للأصول التي يؤمن بها الإمام (قدّس سرّه)، تبقى مسألة اعتقاده بعدم خطأ الشعب في رأيه حتى في ظل حكومة الفقيه العادل، مسألة مبهمة إلاّ إذا حدد حق انتخاب الشعب برأي الفقيه الجامع للشرائط.
إذن، الإمام (قدّس سرّه) لم يتطرق في كلامه طيلة هذه الفترة بوضوح إلى كيفية معرفة الفقيه العادل وتوليه لمنصب الحكومة، اقتصر ذلك على ما جاء في مؤلفاته الفقهية حول المرجع وإمام الجماعة؛ لكنه بعد انتصار الثورة الإسلامية أيد الأسلوب الذي تم إقراره في الدستور بتوكيل مسألة تعيين القائد إلى مجلس الخبراء.
ففي تاريخ 9 / 2/ 1368 كتب الإمام رسالة إلى رئيس لجنة مراجعة الدستور، جاء فيها:
«إذا ما أيد الشعب الخبراء في مسألة تعيين مجتهد عادل لقيادة حكومتهم، فعند تعيينهم شخصاً لتولي منصب القيادة فإنه سيحظى حتماً بقبول الشعب. وفي هذه الحالة سيكون الولي المنتخب من قبل الشعب، وسيكون حكمه نافذاً عليهم»[56].
كيفية تشخيص فقدان العدالة:
كما قيل سابقاً أن العدالة ملكة؛ لذا من الممكن أن تتغير لما يناقضها. فإذا ما اتفق أن ارتكب الولي الفقيه كبيرة وفقد عدالته، حينئذٍ كيف يمكن عزله من الحكومة؟ وفي دفاعه عن نظرية ولاية الفقيه وتوضيح تباينها من الديكتاتورية، أكد الإمام (قدّس سرّه) أن الفقيه إذا ما ارتكب ذنباً فإنه سيفقد عدالته ولا يمكنه البقاء في منصب القيادة وسيعزل من منصبه تلقائياً.
وحول هذا الموضوع، نقرأ في كتاب ولاية الفقيه:
«إذا ما قام الفقيه بعمل يخالف أحاكم الإسلام، كأن ارتكب معاذ الله فسقاً، فإنه سيعزل عن الحكومة تلقائياً»[57].
كذلك في كلام له قبل انتصار الثورة الإسلامية حول خصائص الحكومة الإسلامية، قال الإمام (قدّس سرّه):
«إن الإسلام وضع لمسألة الولاية على الشعب مجموعة من الشروط ينبغي توفرها في الشخص الذي يريد التصدي لقيادة الشعب، فإذا ما فقد شرطاً واحداً منها، سيسقط تلقائياً عن منصبه؛ ولا يحتاج بعدها إلى اجتماع الناس»[58].
وفي مقام الرد على المخالفين لولاية الفقيه التي يعبرون عنها بمعنى الديكتاتورية قال الإمام:
«إن الإسلام يدين الدكتاتورية، الإسلام يسقط ولاية الفقيه المتشبث بالدكتاتورية»[59].
وبشكل عام يعتبر سماحة الإمام، أن الفقيه الجامع للشرائط له الولاية ثبوتاً، استناداً لأدلة تنصيب الفقيه كخليفة للإمام المعصوم (ع). فإذا ما توفرت أرضية التصدي لهذا المنصب وإعمال الولاية للفقيه ـ وقد علمنا أنه يجب على الفقيه الجامع للشرائط أن يهيأ هذه الأرضية بنفسه ـ حينئذ يكون حاكماً إثباتاً. بناء على هذا إذا ارتكب الولي الفقيه ذنباً ثبوتاً تسقط منه الولاية، وإن لم يعلم بذنبه أحد; بمعنى أنه: لو ارتكب الولي ذنباً ستسقط ولايته تلقائياً. والسؤال الذي ما زال يطرح هنا هو: مَن الذي يشخص وكيف يشخص فقدان العدالة، وبعبارة أخرى كيف يتم عزل الولي الفقيه من السلطة إثباتاً؟
وبعد أن يؤكد الإمام (قدّس سرّه) على أن الفقيه الفاقد للعدالة سيسقط تلقائياً من الحكومة دون الحاجة إلى استقالته أو عزله، يقول: والشعب أيضاً يجب أن يعزله[60]. لكنه لم يوضح كيف يتم ذلك. ويمكن القول أن الإمام (قدّس سرّه) قد بدأ الطريقة التي يتم فيها عزل القائد بعد عجزه عن أداء وظائفه أو فقدانه لشروط القيادة، والتي تم إقرارها في الدستور عام: (1358ﻫ.ش)، حيث أوكل هذه المهمة إلى مجلس الخبراء؛ لكن ينبغي التأكيد مرة أخرى على أن دور مجلس الخبراء إنما يقتصر على الكشف والتشخيص ولا يحق له مستقلاً عزل ونصب القائد.
كيفية المحافظة على ملكة العدالة وتقويتها:
كيف يمكن للفقيه العادل المحافظة على عدالته وتقويتها في نفسه؟ إن المراقبة والمحاسبة[61] هما شرطان أساسيان في تهذيب النفس، ويعملان على المحافظة على العدالة وتقويتها في النفس؛ لذا ينبغي على الحاكم الإسلامي أيضاً الإكثار من العبادة والمناجاة ومراقبة نفسه ومحاسبتها حتى يتمكن من الحيلولة دون تقوية جذور الذنوب في قلبه، وينبغي عليه أيضاً معرفة الآفات التي يمكن أن تصيب أصحاب الجاه والمنصب حتى يتمكن من مواجهتها ومقاومتها. وأهم هذه الآفات هي آفة تزلف وتملق حاشيته من حوله له.
1ـ الابتعاد عن التزلف والتملق
إن التزلف والتملق آفة تهدد كلاًَ من الرئيس والمرؤوس على حد سواء.
إن الطالبين للرئاسة وأنواع الاحترام الظاهري يتملقون لمؤيديهم ويتخضعون لهم حتى يكسبوا تأييدهم بأي شكل. وهكذا تدور هذه العجلة بالدور والتسلسل حتى يتملق المؤيدون لرؤسائهم ويتملق طلاب الرئاسة لمؤيديهم والعاملين معهم[62].
وتكمن علة ارتياح الإنسان لتملق الآخرين وتزلفهم، في آفة حب النفس التي تعد أقوى فخاخ إبليس اللعين[63].
لذا يجب على الحاكم الإسلامي مواجهة تملق الآخرين له ومنعهم من الاستمرار في هذا العمل. وقد أكد الإمام (قدّس سرّه) في سيرته العملية كثيراً على هذا المنهج، ونشير هنا إلى بعض الأمثلة على ذلك:
حول الأشعار التي ألقيت في مدحه كان الإمام (قدّس سرّه)، يقول:
«هذه الأشعار التي ألقيتموها جيدة لكنها غير صحيحة بالنسبة لي (...) ويمكنكم ثناء الله وشكره أن منَّ علينا بمثل هذا التوفيق»[64].
وفي مكان آخر، عندما تحدث أحد الحاضرين بكلام يمتدح فيه الإمام (قدّس سرّه)، ردّ عليه الإمام قائلاً:
«أنا أرفض هذه المبالغات التي تحدثتم بها عني (...) لقد تحدث ـ الشاعر ـ ببيان حسن، لكنه بالغ في مدحي، وخاصة عندما يكون هذا المدح بحضور الشخص ذاته، إذ يمكن أن يصدق هذا الكلام، فيتعرض للغفلة ويجلب المصائب على المجتمع»[65].
كما اعترض الإمام (قدّس سرّه) على كيفية عرض الأخبار التي تتحدث عنه في الإذاعة والتلفزيون والصحف، فقال:
«أنا لا أتحدث عن الآخرين، لكن عن نفسي أقول بأني غير راض عن وضع الإذاعة والتلفزيون. فالواقع أننا ليس لنا حق في الإذاعة والتلفزيون كما للفقراء والمحرومين (...) فمنذ فترة طويلة لاحظت أني كلما فتحت المذياع والتلفزيون أجدهم يذكرون اسمي»[66]. فامتعض من ذلك.
2ـ النصيحة:
إن مسؤولية المحافظة على عدالة نفس الحاكم الإسلامي لا تقتصر على الحاكم فقط؛ بل كلّ شخص يمكنه بالموعظة والنصيحة تذكير الحاكم الإسلامي بمسؤولياته ووظائفه والمساعدة في تقويته في مواجهة طغيان النفس وجموحها:
على الإنسان أن يعظ الآخرين ويتقبل الموعظة من الآخرين. فلا يوجد إنسان لا يحتاج إلى الموعظة، وفقط الأولياء يعظهم الله، وهم يعظون من دونهم من الناس حتى يصل إلى الآخر ثم يصل إلينا، فنحن نحتاج إلى الموعظة (...)[67].
العدالة والاشتباه:
1ـ العصمة والعدالة:
هنا ينبغي الإشارة إلى التفاوت المهم الموجود بين العصمة والعدالة. فالعصمة تعني الابتعاد عن أي ذنب واشتباه، في حين تعني العدالة الاجتناب عن الذنب وهي لا تتعارض مع الخطأ والاشتباه. وقد صرح الإمام عدة مرات باحتمال اشتباه الولي الفقيه رغم عدالته.
وفي معرض إجابته على سؤال مراسل مجلة (تايم) عندما سأله: هل حدث أن اشتبهتم في موضوع ما؟
الرسول محمد (ص) والأنبياء الآخرين هم الذين لم يقعوا في الاشتباه فقط، وكل شخص غيرهم معرض للخطأ والاشتباه[68].
وفي رد فعله على الصراعات الطويلة بين الأحزاب في السنة الأولى من انتصار الثورة الإسلامية والتي أدت إلى حدوث الفوضى، صرّح الإمام:
«إن الاشتباه الذي وقعنا فيه أننا لم نعمل كما في الثورات ومنحنا الفرصة لهذه الطبقات الفاسدة. واستمراراً لحديثه يعتذر الإمام من الله تعالى ومن الشعب»[69].
وفي كلام آخر يشير الإمام (قدّس سرّه) إلى أحداث كردستان وعدم تعامل الحكومة المؤقتة بجدية مع المتخلفين ويقول:
«منذ البداية وحسب الإلزام الذي كنت أتصوره، أدركت أننا أخطأنا بتشكيل الحكومة المؤقتة»[70].
وفي آخر وصيته بعد أن أكد على أن الميزان عند كلّ شخص هو وضعه الفعلي[71]، أشار الإمام (قدّس سرّه) إلى بعض الأفراد الذين مدحهم طيلة فترة النهضة نتيجة لتزلفهم وتظاهرهم بالإسلام.
من الأمور السيئة المنافية للعدالة التي يجب اجتنابها، الإصرار على الخطأ وإلا فالخطأ والاشتباه في حد ذاته ليس عيباً. وعدول الفقهاء من فتوى إلى فتوى أخرى يتضمن هذا المعنى، إذ عندما يعدل الفقيه عن فتواه فهذا يعني أنه قد أقر باشتباهه في هذه المسألة[72]، وعلى هذا الأساس، يقول الإمام (قدّس سرّه) حول هذا الموضوع:
«ليس من الصحيح أننا إذا ما قلنا كلمة وفقاً لما كنا قد رأيناه مناسباً لمصالح الإسلام، وبعد ذلك رأينا آنفاً أخطأنا في التشخيص وأن الأمر ليس كذلك، نقول أننا نصرّ على اشتباهنا، فنحن ما أن نعلم أننا قد أخطأنا في ما قلناه اليوم وأن الصحيح هو أن نعمل بشكل آخر، فإننا نعلن بصراحة أننا قد أخطأنا، ويجب أن نعمل بهذا الشكل، فنحن نسعى لتأمين مصالح المسلمين وليس للإصرار على كلامنا»[73].
إن إصرار الولي الفقيه على الخطأ ينافي العدالة من جهتين على الأقل.
الأولى، أنه لم يلاحظ فيها حال الإسلام والمسلمين[74] ورعاية مصالحهم، وهذا يخالف العدالة.
الثانية: إن الإصرار على الخطأ ينشأ عن ضعف النفس وحب السلطة التي تؤدي إلى الديكتاتورية، وهذا ينافي العدالة. وفي هذا الموضوع يوصي الإمام قادة المستقبل، فيقول:
«أنتم تعلمون أن الإنسان غير معصوم من الاشتباه والخطأ. فما أن تحرزوا وقوعكم في الاشتباه والخطأ، عليكم الرجوع عنه والاعتراف بخطئكم، فهو من الكمال الإنساني، وتبرير الخطأ والإصرار عليه يعد نقصاً ومن عمل الشيطان»[75].
2ـ كيفية التمييز بين الذنب والاشتباه:
هنا يطرح السؤال التالي: كيف يمكن التمييز بين الاشتباه والذنب؟ من الواضح أن الإمام (قدّس سرّه) يعتبر الإصرار على الخطأ ذنباً يوجب سقوط العدالة[76]. والديكتاتورية إحدى نماذجه، فهي من وجهة نظر الإمام (قدّس سرّه) صفة نفسانية قبل أن تكون نوعاً خاصاً للنظام السياسي، ومن أهم ما تتصف به الديكتاتورية الإصرار على تحميل رأيه على الآخرين حتى لو كان خطأ. فمن وجهة نظر الإمام منشأ الديكتاتورية هو السلوك القائم على حب السلطة الناشئ من حب النفس؛ لذا إذا ما أصر الولي الفقيه على خطأه الواضح فإن ذلك يسقط عدالته.
تعد هذه القاعدة الوحيدة التي ذكرها الإمام للتمييز بين الذنب والاشتباه، ويبقى الحد الفاصل بينهما غير واضح في كثير من الموارد؛ على الرغم من أننا لا يمكننا القول أن الخطأ الذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة أو أضرار فادحة توجب تلقائياً سقوط عدالة الولي الفقيه أو لا؛ لأن الفرض في الإنسان العادل هو عدم تعمده الخطأ[77]، وتعثره لا ينشأ عن إتباعه لأهواء النفس[78]. إذن، ونتيجة لوجود حسن الظن في الولي الفقيه القائم على أساس رؤيته الفاضلة للسلطة ـ واعتبار حسن الظاهر هو المعيار في تشخيص العدالة، ولا يعلم حقيقة الأمور إلاّ الله تعالى، يصبح من الصعب عملياً التمييز الصحيح بين الذنب والاشتباه.
الحلول المناسبة للحيلولة دون وقوع الاشتباه:
بعد أن اتضح أن الولي الفقيه يمكن أن يتعرض للاشتباه، كيف يمكن أن نقلل من احتمال وقوعه إلى أدنى حد ممكن؟ لهذا الغرض يمكن أن نذكر نوعين من الحل هما:
1ـ الشورى:
أهم الحلول التي طرحها الإمام للحيلولة دون وقوع الولي الفقيه في الاشتباه في اتخاذ القرارات، هو استعانته بالمشورة التي تعد أحد الأوامر الإسلامية[79]. فقد أوصى الإمام القادة بعده الاستعانة بالمشورة مع المختصين في الأمور المهمة ورعاية جانب الاحتياط[80].
وكان الإمام نفسه في اتخاذه القرارات المهمة يهتم برأي المختصين ويتشاور معهم.
لكن الإمام (قدّس سرّه) كان يعتقد أن الشورى بالنسبة للقائد لها صفة الاستئناس وليس الوجوب؛ أي أن رجوع الولي الفقيه لرأي الشورى أمر جائز وليس بواجب، إذا ما اتخذ الولي الفقيه رأياً صريحاً وقاطعاً في مسألة معينة حينها لا يجب عليه الرجوع إلى الشورى.
فمثلاً حول المادة (162) من الدستور المصوب عام: (1358هـ ش)، التي كلفت القائد بتعيين رئيس محكمة التمييز والمدعى العام بالتشاور مع قضاة محكمة التمييز، يقول الإمام (قدّس سرّه):
«في المادة الدستورية التي تقول أن القائد هو من يعين المدعي العام ورئيس محكمة التمييز بالتشاور مع القضاة، لها موضوعية من جهتين: الأولى أن التشاور يتم عند وجود الشبهة، أما في الأمور الواضحة التي لا شبهة فيها فلا حاجة للمشورة؛ فمثلاً إذا ما حصلت الشبهة بين عدة موارد يريدون التصدي لمنصب المدعي العام، ولا نعرف حالهم، ينبغي حينئذٍٍ التشاور مع القضاة في هذا الاشتباه، لكن لا موضوعية له هنا لأن الاشتباه لم يصدر عنه»[81].
ونظراً لأن الإمام (قدّس سرّه) كان يعتقد بجواز الرجوع إلى الشورى، من الواضح أنه لا يرى وجوب إتباع الولي الفقيه لرأي الأغلبية، حتى أنه في الموارد التي كان يطلب المشورة فيها كان هو من يتخذ القرار النهائي ولا يلتزم حتماً برأي أغلبية أعضاء الشورى، فكان يعمل حسب تفسير الآية: (159) من سورة آل عمران التي توكل الرسول الأكرم (ص) اتخاذ القرار النهائي[82]. فمثلاً كان الإمام يناقش القرارات التي تصدر عن جلسات التشاور مع رؤساء السلطات الثلاثية، ثم يتخذ قراره النهائي على ضوء ذلك؛ لكنه عادة ما كان يحترم رأي الشورى. (...) حيث عادة ما كان يقبل برأيهم في المسائل المالية والاقتصادية، لكنه كان يتدخل في المسائل المرتبطة بالحرب ويردّ بعض آراء الشورى[83]. وأحياناً كان الإمام في المسائل المهمة جداً يقبل برأي الشورى، ولعل أهم الأمثلة على ذلك، ما حدث عند قبوله قرار مجلس الأمن رقم 598:
بالنظر للأحداث والعوامل التي أتجنّب الآن عن الخوض فيها، وأرجوا من الله أن تتضح لكم في المستقبل وتبعاً لرأي جميع المختصين السياسيين والعسكريين في البلاد ممن أثق بالتزامهم وحرصهم وصدقهم، وافقت على القبول بقرار وقف إطلاق النار، واعتبره في الوقت الحاضر في مصلحة الثورة والنظام[84].
وفي أحيان أخرى، كان الإمام (قدّس سرّه) يقبل برأي الشورى رغم مخالفته لرأيه، ومن أهم الأمثلة على ذلك استناداً إلى كلام حجة الإسلام السيد أحمد الخميني:
في أحداث مدينة خرمشهر كان الإمام يعتقد أنه الوقت الأفضل لإنهاء الحرب، لكن المسؤولين العسكريين قالوا ينبغي أن نتحرك نحو منطقة قريبة من شط العرب حتى نتمكن من مطالبة العراق بتعويضات الحرب، فلم يكن الإمام موافقاً من الأساس على هذا الرأي، وكان يقول إذا أردتم الاستمرار في الحرب، فاعلموا أن الحرب إذا ما استمرت على هذا الوضع ولم تتفقوا فيها فإنها لن تنتهي بعد ذلك ويجب علينا حينئذٍٍ الاستمرار فيها إلى نقطة معينة، لكن بعد أن تم تحرير خرمشهر اعتقد أنها الفرصة المناسبة لإنهاء الحرب[85].
لكن رغم ذلك، كان الإمام (قدّس سرّه) يواجه بشدة من يشيع أنه كان تابعاً لقرارات الآخرين، وكان يؤكد على استقلاله في اتخاذ القرارات:
«أود أن أبين للجميع أني عندما دخلت هذا المجال، لم أسمح منذ البداية لأي شخص بالتدخل، حتى المقربين مني لم أسمح لهم أبداً بالتدخل، فأنا مستقل في العمل بوظائفي»[86].
2ـ النقد:
إن النقد والإرشاد والدعوة إلى الخير استناداً إلى رواية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هو فريضة جماعية لا تقتصر على طبقة خاصة من الناس:
«إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلان أساسيان في الإسلام هدفهما إصلاح كلّ شيء، وقد أراد الإسلام بهذين الأصلين إصلاح جميع فئات المسلمين، وقد أمر الجميع دون التمييز في هذا الأمر بين الفئات المختلفة بوجوب إطاعة الله تعالى»[87].
إن الصفة الجماعية لهذه المسؤولية تقتضي شمول الجميع بها حتى الولي الفقيه؛ لهذا إذا ما رأى أحد الأفراد حتى لو كان بنظر الناس صغيراً، فرداً آخراً حتى لو كان كبيراً بنظر الناس، يرتكب خطاً معيناً، فيجب عليه كما أمره الإسلام مواجهته ونهيه ويخبره أن هذا العمل خطأ[88].
وعلى هذا الأساس، لا يوجد أي شخص في المجتمع الإسلامي مصون من النقد؛ لأن عدم انتقاد الشخص يعني أنه مصان من كلّ عيب وخطأ، رغم أنه لا يمكن لأي شخص أو مؤسسة أو نظام الإدعاء بعدم وجود نقص فيه، وإذا ما ادعى ذلك فهذا أكبر نقص فيه[89]. والإمام يعتقد أساساً أن عدم قبول النقد ناشئ من حب النفس؛ لهذا نرغب أن يمدحنا الآخرون حتى لو مجّدوا لنا أفعالنا السيئة وحسناتنا الوهمية أكبر من حقها مئات المرات، ونغلق أبواب النقد حتى لو كان بحق أو يتحول إلى مدح وثناء[90]. وعلى هذا الأساس، يمكن القول أن عدم القبول بالنقد ناشئ عن عدم اعتدال النفس، ومثل هذا الشخص لا يعتبر عادلاً[91].
لكن ينبغي علينا التمييز بين النقد والمؤامرة، فلا إشكال في النقد والجميع أحرار في ذلك، لكن لا يمكن القبول بالمؤامرة أبداً. وحول التفاوت بين النقد والمؤامرة، يقول الإمام (قدّس سرّه):
«إن لهجة المؤامرة تختلف عن لهجة النقد، فالنقد من الأمور البناءة، فالعلوم الإسلامية لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون النقاش العلمي، كذلك الأمور السياسية لا تصل إلى الهدف المطلوب دون النقاش والبحث فيها (...) ولا يمكن لأي شخص أن يوقف أو يمنع ذلك لكن اللهجة تختلف أحياناً فلا تعدّ لهجة نقد حينها وإنما تتحول إلى لهجة إضعاف للجمهورية الإسلامية (...) ونحن نخالف مثل هذه اللهجة، ولا نسمح بها، لأن المؤامرة غير جائزة، لكن الجميع أحرار في النقد»[92].
وعلى هذا الأساس، في عام: 1358 أقدم الإمام (قدّس سرّه) على مواجهة بعض التيارات السياسية والصحف المرتبطة بها، مما أدى إلى تحديد بعض الحريات في بداية الثورة:
«لقد منحنا الآخرين الحرية لكنهم أساءوا استغلالها، لذا لن نمنحهم الحرية بعد ذلك . فإذا كانت الحرية تعني أن نسمح لهم بأن يسيئوا للنظام كما يحلو لهم، فهذه ليست حرية، إنما الحرية حسب ما تقتضيه حدود الإسلام وحسب ما يسمح الإسلام لنا به، والإسلام لا يسمح لنا أن نترك كلّ شخص يتآمر على النظام كما يريد»[93].
«وبعد هذا الخطاب أمر الإمام بحظر أنشطة بعض الأحزاب، وأمر المدعي العام في محكمة الثورة بحظر انتشار المجلات المتآمرة التي تعمل ضد مسيرة الشعب ومحاكمة الكتاب العاملين فيها»[94].
وعلى ضوء ذلك يمكن أن نستنبط أن المخالفة العملية هي الحد الفاصل بين النقد والمؤامرة، وهذا يعني أنه لا يحق لأي شخص في المجتمع الإسلامي إبداء المعارضة العملية للولي الفقيه أو الحكومة الشرعية المنصوبة من قبله. وحول الحكومة المؤقتة للمهندس بازرگان يقول الإمام (قدّس سرّه):
«لقد نصبته حاكماً، فيحكم الولاية التي أحملها من قبل الشارع المقدس قد عينته بهذا المنصب، ويجب إتباع من قد عينته؛ ويجب على الشعب إتباعه فهذه ليست حكومة عادية بل هي حكومة شرعية (...) ومعارضة هذه الحكومة تعد معارضة للشرع»[95].
وفي خطابه لمن كان يخالف القيام بالإضراب، قال الإمام:
«اليوم، الإضراب حرام شرعاً، ومن يقوم بالإضراب يعتبر خائناً للإسلام»[96].
وفي موضع آخر، يحكم الإمام بحرمة معارضة الحكومة الإسلامية، ويقول:
«معارضة الحكومة الإسلامية يخالف إحدى ضروريات الإسلام، وهو مخالف للإسلام بالضرورة، لأن الحكومة الآن حكومة إسلامية (...) ومعارضة الحكومة الإسلامية يعد بحكم الكفر، وأكبر من جميع المعاصي»[97].
النتيجة:
من مجموع ما تقدم في هذا البحث، نستنتج أن الإمام (قدّس سرّه) وحسب رؤيته الفاضلة والشخصية للسلطة، كان يعتقد أن سلامة الحكومة وصلاحها يكمن في تصدي الفقيه العادل لها لأن عدالة الفقيه تحول دون استغلاله للسلطة. ولما كانت العدالة لا تتعارض مع الاشتباه وتربص الشيطان والنفس الإمارة للإيقاع بالإنسان، كان الإمام يوصي بضرورة أن يستفيد الولي الفقيه دائماً من نصائح الآخرين ومواعظهم ومشورتهم وانتقاداتهم حتى يحصن نفسه من ارتكاب الذنوب والوقوع في الاشتباه، ويتمكن من قيادة الحكومة والمجتمع نحو غايتهما الحقيقية.
[1]) محمد باوي، قدرت از ديدگاه امام خميني، فصلنامة علوم سياسي (خريف 1377، العدد: 2).
[2]) روح الله الخميني، موعد اللقاء، رسائل الإمام الخميني إلى نجله السيد أحمد الخميني (طهران: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1374) ص 83.
[3]) روح الله الخميني، شرح الأربعون حديثاً (طهران مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1374)، ص49.
[4]) المصدر السابق، وكذلك: روح الله الخميني،، جهاد أكبر يا مبارزة با نفس (طهران: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1372)، ص49.
[5]) روح الله الخميني، الكوثر، مجموعة خطابات الإمام مع شرح لأحداث الثورة الإسلامية (طهران: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني،1371)، ج:1، ص: 237.
[6]) شرح الأربعون حديثاً، ص: 510ـ511.
[7]) المصدر السابق، ص:391.
[8]) مرآة العقول، ج:10، ص: 312، كتاب نور الإيمان باب إتباع الهوى، الحديث:1.
[9]) شرح الأربعون حديثاً، ص: 169.
[10]) المصدر السابق، ص: 6.
[11]) موعد اللقاء، ص: 107.
[12]) المصدر السابق، ص: 108ـ109.
[13]) المصدر السابق، ص:110.
[14]) المصدر السابق، ص: 112.
[15]) المصدر السابق، ص: 113.
[16]) المصدر السابق.
[17]) المصدر السابق، ص: 114.
[18]) روح الله الخميني، تحرير الوسيلة (طهران: مكتبة اعتماد كاظمي، 1366)، ج: 1، ص: 11.
[19]) المصدر السابق، ج: 1، ص: 232.
[20]) المصدر السابق، ص: 233.
[21]) المصدر السابق.
[22]) المصدر السابق.
[23]) روح الله الخميني، الرسائل (قم مؤسسة إسماعيليان، 1368)، ج: 2، ص: 101 ـ 102؛ تحرير الوسيلة، ج:1، ص: 415.
[24]) روح الله الخميني، كشف الأسرار، ص: 281.
[25]) المصدر السابق، ص: 234.
[26]) محسن كديور، نظريه هاى دولت در فقه شيعه (طهران: نشرني، 1376)، ص: 140.
[27]) روح الله الخميني، الحكومة الإسلامية (طهران: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1373)، ص:47.
[28]) المصدر السابق، ص: 38.
[29]) المصدر السابق، ص: 38ـ 39.
[30]) المصدر السابق، ص: 60ـ61.
[31]) المصدر السابق، ص: 52.
[32]) روح الله الخميني، صحيفة نور، مجموعة رهنمودهاى حضرت امام خميني (قدّس سرّه).
[33]) المصدر السابق، ج: 5، ص: 107، ج: 8، ص:439ـ440.
[34]) جهاد أكبر، ص: 61ـ62.
[35]) المصدر السابق.
[36]) المصدر السابق، ص:22؛ في موارد متعددة كان الإمام يوصي رجال الدين بتهذيب النفس، للاطلاع على أمثلة أخرى، صحيفة نور، (تهران: مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1368)، ج:18، ص: 47؛ ج:3، ص: 394ـ 396؛ الكوثر، ج:1، ص: 196ـ 214.
[37]) تحرير الوسيلة، ج:1، ص: 11.
[38]) المصدر السابق، ص: 233.
[39]) المصدر السابق، ص: 11و234.
[40]) المصدر السابق، ص: 233.
[41]) المصدر السابق، ص: 235.
[42]) المصدر السابق.
[43]) محمد رضا توسلي ، أمير رضا ستوده (جمع وتأليف) پا به پاي آفتاب: گفته ها ونگفته ها از زندگي امام خميني (تهران: نشر پنجره، 1374)، ج:1، ص: 283.
[44]) للاطلاع، راجع: الكوثر، ج: 1، ص: 194؛ الحوار الذي جرى بين الإمام وآية الله العظمى السيد الحكيم المذكور في هذا الكتاب، يبين رؤية المراجع في تلك الفترة حول مسألة السياسة ودورهم ودور الناس فيها.
[45]) بعد طرحه لمباحث ولاية الفقيه في سنة 1348، لم يتحدث الإمام بعد ذلك أبداً بصراحة عن ولاية الفقيه إلى أن تم مناقشتها بشكل نهائي في المجلس، حيث أعلن الإمام تأييده لها. لكن حتى في تلك الفترة التي لم يذكر فيها الإمام ولاية الفقيه، ورغم تأكيده على رأي اعتماد الشعب، كان يستند في شرعية قراراته على حق الولاية الشرعية. وحول هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى أمره في تأسيس مجلس قيادة الثورة وخطابه بعد تعيين المهندس بازرگان لمنصب رئيس الوزراء. (صحيفة نور، ج: 3، ص: 105؛ الكوثر، ج:3، ص: 170و 178ـ 180).
[46]) الكوثر، ج: 2، ص: 265.
[47]) المصدر السابق، ص: 285.
[48]) المصدر السابق، ص: 284.
[49]) المصدر السابق، ص: 297.
[50] المصدر السابق، ص: 35ـ 36.
[51]) روح الله الخميني، طليعه انقلاب اسلامى (اللقاءات الصحفية مع الإمام في النجف وباريس وقم)، (تهران؛ مركز نشر دانشگاهي، 1362)؛ ص: 172.
[52]) الكوثر، ج: 2، ص: 550.
[53]) المصدر السابق، ص:551.
[54]) المصدر السابق، ص:548.
[55]) المصدر السابق، ص:550.
[56]) صحيفة نور، ج:21، 129.
[57]) ولاية الفقيه، ص: 61.
[58]) الكوثر، ج:1، ص:287ـ 288.
[59]) صحيفة نور، ج: 6، ص: 165.
[60]) الكوثر، ج: 1، ص: 507.
[61]) شرح الأربعون حديثاً، ص: 9؛ صحيفة نور، ج: 8، ص: 113.
[62]) المصدر السابق، ص:560ـ 561.
[63]) موعد اللقاء، ص: 111.
[64]) صحيفة نور، ج: 4، ص: 226.
[65]) المصدر السابق، ج:3، ص: 392؛ أبدى الإمام رد فعل مشابه حول كلام السيد فخر الدين الحجازي وآية الله المشكيني؛ المصدر السابق، ج: 7، ص: 256؛ ج: 2، ص: 153.
[66]) المصدر السابق، ج: 19، ص: 206؛ المصدر السابق، 215.
[67]) المصدر السابق، ج: 8، ص: 442.
[68]) المصدر السابق، ج 7، ص 16؛ كذلك؛ المصدر السابق، ج: 6، ص: 339.
[69]) المصدر السابق، ج: 5، ص: 305.
[70]) المصدر السابق، ج: 6، ص: 404؛ المصدر السابق، ص: 407.
[71]) المصدر السابق، ج: 18، ص: 178.
[72]) المصدر السابق.
[73]) المصدر السابق، ج: 9، ص: 447.
[74]) الحكومة الإسلامية، ص: 74.
[75]) صحيفة نور، ج: 18، ص: 43، المصدر السابق، ج:8، ص: 236.
[76]) المصدر السابق، ج: 5، ص: 436.
[77]) الكوثر، ج:2، ص:553.
[78]) صحيفة نور، ج:21، ص: 188.
[79]) المصدر السابق، ج:20، ص: 194.
[80]) المصدر السابق، ج:18، ص: 43.
[81]) صحيفة نور، ج:7، ص:153.
[82]) الإمام السيد علي الخامنئي، گفتاري درباره حكومت علوي (بي م: حزب جمهوري اسلامي، 1360)، ص:94.
[83]) آية الله السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي: ستوده، المصدر السابق، ج:2، ص: 201 ـ 202.
[84] صحيفة نور، ج:20، ص: 239.
[85]) السيد أحمد الخميني، مجموعه آثار يادگار إمام (طهران: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1374، ج:1، ص 716)؛ كذلك حول كيفية تعيين بني صدر بمنصب القائد العام للقوات المسلحة بعد التشاور مع الدكتور بهشتي، وآية الله الخامنئي، والشيخ هاشمي رفسنجاني؛ المصدر السابق، ج:1، ص: 112.
[86]) الكوثر، ج: 1، ص: 3؛ السيد أحمد الخميني، المصدر السابق، ج:1، ص: 99؛ آية الله الخامنئي، المصدر السابق، ص: 94.
[87]) صحيفة نور، ج: 5، ص: 550 ـ551؛ المصدر السابق، ج:4، ص: 288 و297؛ ج:6، ص: 74، 144.
[88]) المصدر السابق، ج: 5، ص: 594.
[89]) صحيفة نور، ج: 17، ص: 161.
[90]) موعد اللقاء، ص: 111.
[91]) المرحوم حجة الإسلام السيد أحمد الخميني الذي أقدم في بعض الموارد على تفسير آراء ونظريات الإمام، يشير بصراحة أن الولي الفقيه بعيد عن النقد: لقد قلت عدة مرات أن قائد الثورة الإسلامية ينبغي أن يكون بعيداً عن النقد، لأن القيادة منصب عظيم نحتاج إليه في الظروف الحساسة؛ لكن غير القائد لا يوجد شخص مهما كان منصبه مصون من النقد، وكلما كان منصبه أعلى كلما وجب أن يكون النقد أشد حتى لا يغتر بسلطته ويقدم على ما يخالف مصالح الثورة الإسلامية. السيد أحمد الخميني، المصدر السابق، ج:1، ص: 649؛ لكن طبقاً لتفسير النص الموجود الذي يعبر عن وجهة نظر الإمام، لعل ابن الإمام قد فهم هذه النظرية حسب الظروف الخاصة في تلك الفترة.
[92]) صحيفة نور، ج: 17، ص: 267ـ268.
[93]) المصدر السابق، ج: 5، ص: 296.
[94]) المصدر السابق، ج: 5، ص: 306.
[95]) الكوثر، ج:3، ص: 147.
[96]) صحيفة نور، ج:7، ص: 21.
[97]) المصدر السابق، ج:5، ص: 357.


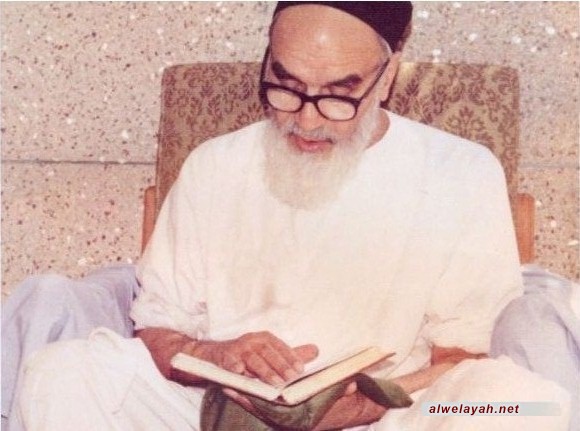









![كلمات مضيئة [47]ـ من مواعظ النّبي(صلى الله عليه وآله): مالي أرى حبَّ الدنيا قد غلب على كثير من الناس..](https://www.alwelayah.net/upload_list/thumbs/news/7e675f8f027.jpg)










تعليقات الزوار